ما بين نعم ولا: ابن رشد وابن العربي - الفرق والجمع بين العقل والقلب
نشر هذا المقال في العدد التاسع من مجلة الإمارات الثقافية التي يصدرها مركز سلطان بن زايد.
مقدمة:
لقد كان اللقاء التاريخي بين اثنين من أساطين الفكر الإسلامي: ابن رشد وابن العربي، حدثاً فريداً نظراً للاختلاف الكبير في رؤيتيهما للوجود، ولاختلافهم الجذري في طريقة دراسته، فالأوّل فيلسوف يعتمد على النظر والمنطق والثاني صوفي يثق بالذوق والمشاهدة. ولقد شاء ابن العربي أن ينقل لنا الحديث الرمزيَّ المقتضب الذي دار بينهما لما فيه من إشارات بديعة يمكن أن تكون أساساً للجمع بين العقل والشهود، أو بين العلم العقلي النظري والعلم الفيضي الإلهي، من أجل الوصول إلى نظريةٍ متكاملةٍ تستطيع فهمَ الوجود، بطرفيه الطبيعيِّ والروحانيِّ، وتفسيرَ الظواهر الكونيَّة الأساسيَّة كالحركة، وفهم ماهيَّة الزمان والمكان.
اللقاء بين ابن العربي وابن رشد:
دخل ابن العربي طريق التصوّف مبكراً، ولم تلبث شهرته أن بلغت الآفاق وهو صبيٌّ لم يكمل العقد الثاني من عمره، وبدأت أقواله ومعارفه تنتشر ويتردد صداها بين الفلاسفة، مما دعا قاضي القضاة في قرطبة، الفيلسوف ابن رشد، أن يرتّب مع صديقه عليّ ابن العربي، والد الشيخ محي الدين، لمقابلة ذلك الصوفي الشاب لكي يسمع ما يمكن أن يقوله حول فلسفته الأرسطوطاليسية. يروي ابن العربي هذه القصة في الفتوحات المكية فيقول:
ولقد دخلت يوماً بقرطبة على قاضيها أبي الوليد بن رشد وكان يرغب في لقائي لم سمع وبلغه ما فتح الله به عليّ في خلوتي، فكان يُظهر التعجّب مما سمع فبعثني والدي إليه في حاجةٍ قصداً منه حتى يجتمع بي فإنه كان من أصدقائه وأنا صبيّ ما بقل وجهي ولا طرّ شاربي. فعندما دخلت عليه قام من مكانه إليّ محبةً وإعظاماً؛ فعانقني وقال لي: نعم! قلت له: نعم. فزاد فرحه بي لفهمي عنه، ثم إني استشعرت بما أفرحه من ذلك فقلت له: لا! فانقبض وتغيّر لونه وشكّ فيما عنده، وقال: كيف وجدتم الأمر في الكشف والفيض الإلهي، هل هو ما أعطاه لنا النظر؟ قلت له: نعم ... لا، وبين "نعم" و"لا" تطير الأرواح من موادّها والأعناق من أجسادها. فاصفرّ لونه وأخذه الأفكل وقعد يحوقل، وعرف ما أشرت به إليه.[1]
أثار الدكتور محمد المصباحي من خلال تحليله لهذا اللقاء، قضية الفرق والجمع بين طريقة الفلاسفة وطريقة الصوفية في رؤيتهم للوجود وفهمهم له، وأفاض في تفصيل بعض جوانب هتين الرؤيتين المختلفتين أو المتناقضتين، بيد أنه تركنا في النهاية دون إجابة واضحة عن إمكانية الجمع بينهما وتوحيدهما في رؤية متكاملة ترتقي بنا إلى فهم أعمق للوجود وعلاقته بالخالق سبحانه وتعالى.
إنَّ هذه الإشارات والكلمات القليلة بين هذين القطبين من أعمدة الفكر الإسلامي؛ هي محاولة للتعبير بلغةٍ رمزية عمّا قد يستحيل توضيحه باللغة المباشرة. فابن العربي يلمّح هنا إلى شيء يفوق إدراك الإنسان العادي، شيء يبدو مخالفاً لتجربتنا اليوميّة ومن الصعب جدّاً تصديقه. رغم ذلك، من الناحية الأخرى، فهو شيء يمكن تلخيصه في النهاية فقط في كلمتين: "نعم" و"لا"، بل بكلمة واحدة فقط هي "نعم"، لأنّ "لا" هي في النهاية عكس نعم. في الحقيقة إنّ جواب ابن العربي الرقمي هذا: نعم/لا (أو 1/0، صح/خطأ، والذي يعني في النهاية: وجود/عدم) هو أفضل وأقصر تعبير يلخّص عمليّة الخلق الغيبيّة الغامضة.
إنّ صعوبة إظهار هذه الحقيقة العالَمية في كلمات بسيطة تتأتّى من كوننا نعيش في عالَم متنوّع من الكثرة والتعدّد اللانهائي، بينما في نفس الوقت فإنّ الحقيقة وراء هذا العالَم كلّه واحدة وبسيطة ليس فيها تركيب، فالحقيقة النهائية وراء هذا العالَم هي الحقّ سبحانه وتعالى، وهو إله واحد وأحد، بينما العالَم كما يبدو لنا متكثّر ومتعدّد، والمشكلة الكبيرة هي كيفيّة الربط بين الواحد الغيبيّ وهذه الكثرة المشهودة، ربّما من خلال بعض المستويات الأخرى من الوحدة والعدد.
الفرق بين الفلاسفة والصوفية:
يحاول الفلاسفة والعلماء عموماً فهم العالَم من خلال الملاحظات والتجارب، بينم طرق ابن العربي والصوفيّون عموماً طريقاً آخر يعتمد على أنماط من المعرفة تقفز مباشرة إلى العالَم الغيبيّ لتُقارب الحقيقة التي تكون عادة وراء حدود العقل. والعقل الذي يعتمد عليه الفلاسفة والعلماء يصيب في أغلب الأحيان ولكّنه كثيراً م يخطئ إمّا بسبب سوء الحكم أو بسبب خطأ في المقدّمات التي اعتمد عليها، في حين إنّ ابن العربي يؤكّد أنّ العلم الذوقي الكشفي الذي يستمدّ منه الصوفيّون يكون دائماً صحيحاً بشرط سلامة المحلّ المستقبل له، وهو القلب، وإن حصل خطأ فإنّه يحصل في التأويل وليس في أصل الكشف.[2]
من ناحية أخرى، يستعمل الفلاسفة والعلماء المنطق والتجارب لاستنتاج نظريّاتهم وتفسير ملاحظاتهم، بينما يصف الصوفيّون رؤيتهم في أغلب الأحيان من غير شرح مستفيض ولا براهين تقنع العقل الناقد، لا سيما وأنّ بعض العلوم التي يدّعونها تقع خارج حدود العقل والمنطق. وفي النتيجة فإنّ الصوفيّون قد يصلون إلى معرفة الحقيقة بسرعة أكبر وبدقّة أكثر من الفلاسفة (كما يؤكّد ابن العربي من خلال روايته لاجتماعه بابن رشد)، لكنّهم، أي الصوفيّون، يجدون صعوبةً كبيرةً في توضيح وجهات نظرهم إلى الآخرين الذين لم يذوقوها وفق طريقتهم. لذلك فهُم كثيراً ما يستعملون لغة رمزية لأنّهم لو نقلوا لنا كلَّ ما يشاهدونه ببساطة لعميَ ذلك على الناس ولم يفهموه وربّما اتّهموهم بالهرطقة أو الكفر، كما حصل في كثير من الأحيان.
وعلى الطرف الآخر، فإنّ المشكلة في القوانين الحالية ونظريّات الفيزياء وعلم الكون المعروفة حتى الآن، بالرغم من أنّها أثبتت جدارتها وكفاءتها العالية على المستوى العملي والتطبيقي، إلا أنّها أخفقت في كشف الحقيقة النهائية وراء هذ العالَم. فكلّ النظريّات العلمية هي نظريّات وصفية تصف بعض الظواهر وتحاول أن تفسّرها، ولكنّها لا تستطيع أن تجزم بالحقيقة الكامنة وراءها. والسبب وراء عدم قدرة العلم على تقرير حقيقة العالَم وأصله أنّ كلّ النماذج الكونية تحتاج إلى معرفة الشرط الحدّي الأوّلي الذي منه بدأ هذا العالَم، وهذا يبدو مستحيلاً لا يمكن للعقل وحده أن يبلغه، وذلك لكونه هو نفسه جزء من هذا الوجود الذي يحاول فهمه؛ ولا يمكن للجزء أن يدرك الكل! لذلك يحاول العلماء العمل بشكل رجعي بحيث يتعرّفون على الحالات السابقة من خلال معرفتهم بالأوضاع الحالية. وفي النتيجة فإنّ كلّ نظريّات الفيزياء والنماذج الكونية المعروفة، رغم أنّها أدّت إلى مستويات أعلى من الفهم، لكنّها أتت بتناقضات جديدة لا تزال تستعصي على الحلّ. فقد نجحت هذه النظريّات بإعطاء سيناريوهات محتملة عن بنية الكون وآلية الخلق وكيف بدأ، لكنّها أخفقت في وصف الحقيقة كاملة وبدقّة كافية.
لذلك نجد أنّ ابن العربي يؤكّد أنّ حدود أهل الأرصاد تنتهي إلى الفلك الأطلس، لأنَّه الفلك الأوّل المادي، وليس هناك فلك بعده يمكن مشاهدته بالعين أو بأجهزة الرصد،[3] بينما يعتمد الصوفيّون على القلب، ولو أنّه بالنهاية يستخدم العقل وإنّما كأداة مستقبلة وليس كأداة فعّالة ومفكّرة، والعقل كما يقول الشيخ الأكبر محدود فقط من كونه مفكّر وليس محدوداً من كونه عاقل أي مستقبل.[4]
ولكنّ الصوفيّين الذين يدّعون أنّهم وصلوا إلى حالة عالية من الإدراك وتصوّر البنية الغيبيّة للعالم وأصله (أي إلى الشرط الحدّي الأوّلي) لا يعيرون أيّ اهتمام إلى توضيح رؤيتهم هذه للكون وربطها بما يشاهده الفلاسفة والعلماء أو حتى الناس العاديّون. حتى ابن العربي نفسه لم يَخُض كثيراً في هذا المضمار بل صرّح أنّ هدفه ليس شرح بنية العالَم وفهمه بحدّ ذاته، لكنّ ذلك مجرّد وسيلة لاكتساب معرفة أكثر بالخالق تعالى الذي خلق العالَم والإنسان على صورته. ولكنّ الحقّ أنّ ابن العربي في الفتوحات المكية وكتبه الأخرى أعطى بشكل عرضي الكثير من التفسيرات الكونية والتحليلات المنطقيّة لما يشاهده من الأمور الغيبيّة. ولهذا السبب بالتحديد من المهم جدّاً دراسة كتاباته حتى نستطيع رأب الهوّة بين الفلسفة والعلم من ناحية، وبين العلوم الروحانية والإلهية من ناحية أخرى.
العلاقة بين الوحدة والكثرة:
لقد ذكر ابن العربي قصّة اجتماعه بابن رشد ضمن سياق اقتباسه وشرحه لكلمات قطب الأرواح الذي يدعوه "مداوي الكلوم" وهو إدريس عليه السلام الذي رفعه الله مكاناً عليّاً (إلى فلك الشمس، وهي قطب الوجود)؛ فيقول الشيخ محي الدين إنّ هذا القطب هو من أعلم الخلق بالعالَم الطبيعي وتأثيرات العالَم الأعلى عليه، ثم يقول إنّ هذ القطب يقول: "إنّ العالَم موجود ما بين المحيط والنقطة، على مراتبهم وصغر أفلاكهم وعِظمها، وإنّ الأقرب إلى المحيط أوسع من الذي في جوفه؛ فيومُه أكبر ومكانُه أفسح ولسانُه أفصح، وهو إلى التحقق بالقوّة والصفاء أقرب، وما انحطّ إلى العناصر نزل عن هذه الدرجة حتى إلى كرة الأرض".[5]
فالنقطة هنا تشير إلى الحقيقة وهي صورة الحق الواجب الوجود وظاهره في العالَم (وهو الجوهر الفرد)، بينما محيط الدائرة هو مجموع المخلوقات (وهي الموجودات الممكنة الوجود، أي الأعراض والصور التي نراها). وأمّا ما هو بعد هذا المحيط فهو بحر العدم أو الباطل (المستحيل الوجود). والشكل التالي يوضّح هذا التقسيم الذي يعتمد عليه ابن العربي كثيراً، وهو مأخوذ ببعض التصرّف من الباب 360 من الفتوحات المكية.[6]
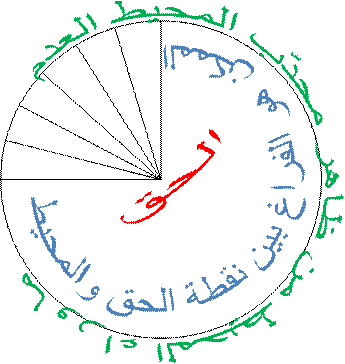
العلاقة بين الحق والخلق والباطل، أو واجب الوجود وممكن الوجود ومستحيل الوجود
ولقد بيَّنا في مقال سابق، نُشر في العدد الأوّل من هذه المجلة، كيف يشرح ابن العربي هذه العلاقة الفريدة بين وحدة الحقّ وكثرة الخلق من خلال فهمه العميق للزمان وتأكيده على مبدء تجديد الخلق الذي ينصُّ على أنّ الأعراض تنعدم في الزّمان الثاني من زمان وجودها؛ فلا يزال الحقّ مراقباً لعالَم الأجسام والجواهر العلوية والسفلية، كلّما انعدم منها عَرَضٌ به وجوده خلق في ذلك الزّمان عرضاً مثله أو ضده يحفظه به من العدم في كل زمان، فهو خلاّقٌ على الدوام، والعالَم مفتقرٌ إليه على الدوام افتقاراً ذاتياً من عالَم الأعراض والجواهر.[7]
تجديد الخلق بين نعم ولا:
يستنتج الشيخ الأكبر فكرة الخلق الجديد من الآية الكريمة: ﴿بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [ق: 15]، كما يستنتج مفهومه البديع للزمان من الآية: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: 29]. فنحن في لَبْسٍ، أي محجوبون في غطاء، عن رؤية هذا الخلق الجديد في كلِّ يوم شأن، أي في كلِّ آن، ولذلك يقول الله تعالى في سورة الكهف: ﴿مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ﴾ [الكهف: 51].
فلو أشهَدَنا الله الخلق كما يجري من قِبل الجوهر الفرد، لرأينا كيف أنّ هذ الجوهر الفرد يقوم بخلق صورة للعالَم في ستّة أيَّام، أي في ستّ جهات ثمّ يستوي الرحمن على العرش في اليوم السابع، فتكون هذه الصورة للعالَم مثل لحظة واحدة بالنسبة لنا، ثمّ يقوم الجوهر الفرد مباشرة بخلق صورة أخرى مماثلة من جديد، وهكذ بشكلٍ دائمٍ ومستمرٍّ؛ ونحن في لَبْسٍ من هذا، فنرى الوجود مستمرّاً، ولا ينبغي له ذلك لأنّه لو كان كذلك لبطل افتقاره إلى الله تعالى لكي يحفظ عليه وجوده.
إذاً فإنّ وجود الأشياء في العالَم هو وجود آني وليس مستمرّاً، كما نرى ونتخيّل، لأن الله يخلق كلّ شيء من جديد بشكل دائمٍ في كلّ لحظة (يوم شأن). هذا يعني كذلك أنّه ليس فقط الزّمان هو الذي يوجد فقط ذرّة واحدة في كلِّ وقت، بل المكان أيضاً. وهذه نتيجة على غاية كبيرة جدّاً من الأهمية بحيث من شأنها أن تقلب مفهومنا عن العالَم وتغيّر الكثير في النظريّات الفيزيائيّة الحديثة. ولقد رأينا في مقال سابق كيف يعطي ابن العربي بهذه الطريقة رؤية مختلفة للحركة من شأنها أن تحلّ معضلات زينون التاريخية.
بالطبع إنّ إعادة الخلق هذه تحدث على جميع مستويات الوجود وبسرعة كبيرة ل يمكننا إدراكها، ولكنّ ابن العربي لا يجد صعوبة في إيجاد الأسباب المنطقية والدينيّة التي تدعم هذه النظرية، فيقول في كتاب "التنـزلات الليلية في الأحكام الإلهية" إنّ الأعراض تنعدم في الزّمن الثاني من زمان وجودها وذلك حتى يكون الحقّ خلاّقاً على الدوام وحتى يبقى الجوهر دائماً مفتقراً إلى الخالق في وجوده. فإذا بقي العرَض زمانين أو أكثر أصبح مستقلاً في وجوده وهذا لا يكون.
وكذلك الجوهر لا يمكن أن يستمرّ وجودُه، لأنّه بحاجة دائمة للحقّ أن يحفظ عليه هذا الوجود، وهذا يتمّ فقط من خلال خلقِ الأعراض فيه، فهو إذاً يلبس في كلّ لحظة عرَضاً جديداً، مثل العرَض الأوّل أو ضدّه، ولكن ليس نفسه.
كذلك يمكن أن نصل إلى نفس هذه النتيجة من حقيقة اسم الله "الواسع" والذي يعني في النهاية أنّه لا تكرار في الوجود، فلو حصل التكرار لم يصحّ إطلاق معنى السعة من اسمه تعالى الواسع.
فالعالَم في كلّ زمانٍ فردٍ يتكوّن ويفسد، ولا بقاء لعين جوهر العالَم لولا قبول التكوين فيه. وكما قال ابن العربي في بداية الفتوحات المكية مستخدماً عبارات مسجوعة على لسان الإمام المغربي الذي اجتمع مع ثلاثة آخرين من الأقطاب فخطب كلّ واحد منهم خطبةً لخّص فيها علمه الذي اختُصّ به، فخطب هذا الإمام وقال من ضمن ما قال: مَن كان الوجود يلزَمُه (مثل الجوهر الفرد والعنصر الأعظم)، فإنَّه يستحيلُ عدَمُه (لأنّ وجوده واجبٌ بالله تعالى)، والكائن ولَم يكن (وهو العَرَض)، يستحيل قِدَمُه، ولو لَم يستحلْ عليه العَدَم، لصَحبه المقابِل (أي الضدّ) في القِدم، فإن كان المقابِل لَم يكن، فالعجزُ في المقابَل مستكِن، وإن كانَ (أي المقابِل) كانْ (أي كائناً في القِدم)، يستحيل على هذا الآخَر كانْ (أي الكون أو الحدوث لأنّه يكون عندئذٍ قديماً)، ومحالٌ أن يزول بذاته لصحَّةِ الشَّرطِ (أي لقِدمِه المفترض) وإحكامِ الرَّبط (أي صلته بخالقه الَّذي أوجب له الوجود).[8]
فهذه التصريحات المقتضبة تعتمد على قضيتين أساسيّتين الأولى أنّ الأعراض لا تبقى زمانين كما أسلفنا، والثانية أنّ فناءها أمرٌ تلقائي وليس بفعل خارجي، وهذه نتيجة منطقيّة لأنها لا يمكن أن تفنى بفعل فاعلٍ، لأنّ الفاعل يفعل شيئاً والفناء لا شيء، فليس هناك فعل نتيجته لا شيء.
في الحقيقة إنّ فكرة إعادة الخلق أو الخلق الجديد موجودة عند علماء الكلام الأشعريّة الذين يزعمون، مثل ابن العربي، أنّ العالَم جواهر وأعراض ولكنّهم يعرّفونها بشكل مختلف لأنّ الأعراض عندهم هي الصفات المتغيّرة مثل اللون، في حين أنّ الجوهر هو الذي لا تتغيّر صفته، ولكنّ ابن العربي يعدّ كلّ الصور في العالَم أعراضاً زائلةً لا تدوم سوى لحظة وجودها وأمّا الجوهر فهو شيء لا يمكن أن نعرف كنه ذاته لأنّه لا يظهر بذاته وإنّما فقط يظهر بهذه الصور التي هي أعراض له، ولقد تكلّمنا عن بعض خصائص الجوهر الفرد والعنصر الأعظم في العدد الثالث من هذه المجلّة.
إذاً، فكلّ الأعراض والجواهر في العالَم يتم خلقها بشكل مستمر ويتجدّد عليه الوجود بشكل دائم من قبل الجوهر الفرد. ولكن لكي نفهم العالَم يجب أن نعرف كيف يقوم هذا الجوهر الفرد بإظهار هذه الصور المختلفة في أنحاء المكان وعبر الزّمان، وهذ يدعونا من جديد للبحث في المعنى الحقيقي لمفهوم الزّمان (والمكان) وآليّة الخلق وترتيبه، وهو الأمر الذي يحتاج بحثاً آخر.
الجمع بين العقل والقلب:
لقد أراد ابن رشد أن يعرف فيما إذا كان ابن العربي يوافق على النظريات الفلسفية ورؤية الفلاسفة للوجود، كما لخَّصها ودافع عنها في كتاب تهافت التهافت مثلاً، والتي تشكِّل في النهاية خلاصة عصارة الفكر الإنساني من الفلاسفة الإغريق كأرسطو ومن سبقه، وأفلاطون ومن تبعه، والفلاسفة المسلمين كالكندي وابن سينا وغيرهم، بما في جميع ذلك من اختلاف واتفاق؛ فكان جواب ابن العربي "نعم"، ولم يفعل كما فعل الغزالي مثلاً في "تهافت الفلاسفة" حين ناقض جميع هذه النظريات. ولكنَّ ابن العربي استدرك وقال "لا" ليؤكِّد أنَّ هذه الرؤية الفلسفية صحيحة فقط فيما يخصُّ الوجود من كونه موجوداً، أي في حال وجوده، ولكن بما أنّه في الحقيقة يتأرجح بين العدم والوجود، أي بين الغيب والشهادة، أو بين الروح والجسم، فإنَّ الجواب هو: نعم ... لا، وبين "نعم" و"لا" تطير الأرواح من موادّها، ويفنى العالم، ثم يعيد الله سبحانه وتعالى خلقه من جديد، في ستة أيام ثم يستوي على العرش، ولا يمسُّه من لغوب، بل هو عليه أهون، ولكننا نحن في لبس من هذا الخلق الجديد، فنظنُّ أنَّ وجود العالم لا يزال مستمراً، لأنَّ الله ما أشهدنا هذا العالم أثناء خلقه ولا أشهدنا خلق أنفسنا، بل أشهدن إيّاه مخلوقاً في ستة أيام، أي في ست جهات.
فالعقل ينظر إلى الظاهر بما فيه من الأجسام والصور فيراها حقائق قائمة بذاته فيدرسها ويحاول فهم قوانينها، والقلب (حين يصفو وتنفتح عيونه على عالم الغيب) يشاهد الروح وقيامها في هذه الصور التي يراها مجرَّد أعراض وخيال لا يلبث أن يزول في الزمن الثاني بعد وجوده، ليظهر من جديد في صور أخرى مشابهة توهمنا باستمرار الوجود.
فالعالَم من حيث ظاهره أجسام متعدِّدة ذات أبعاد وصفات كثيرة كاللون والحجم والرائحة والكتلة، وهي تتفاعل مع بعضها البعض وتؤثِّر وتتأثّر، ونحن نُدرك ذلك من خلال السمع والبصر واللمس وغير ذلك من الحواس، ثم نحلِّل هذه الإدراكات في العقل ونبني عليها النظريات العلمية والفلسفية. وهذا هو الفضاء الذي يسبح فيه الفلاسفة والعلماء في محاولاتهم الحثيثة لفهم هذا الوجود واكتشاف قوانينه ونظرياته.
أمّا من حيث الباطن، وهو الحقيقة الكامنة وراء هذا الوجود، فإنَّ هذه الظواهر التي نراها في الوجود ليس لها حقيقة ذاتية، وإنّما هي أعراض تحدث في الجوهر كم قلنا، والجوهر الفرد هو الوحيد الذي له حقيقة في هذا الوجود. من أجل ذلك يؤكِّد ابن العربي أنّ معظم الخواص المعروفة للمادّة مثل الوزن والكثافة والشفافيّة والنعومة لا تتعلّق حقيقة بالأجسام نفسها بل بالعقل الذي يدركها. ولا شكّ في أنّه من الصعب جدّاً قبول مثل هذه الفرضيّة، خصوصاً وأنّها تناقض تجربتنا اليومية بشكلٍ واضح، ول يمكن أن نفهم ذلك إلا على أساس مبدء تجديد الخلق.
وكذلك فإنّ بُنية الكون عموماً، بما فيه من كواكب ونجوم ومجرّات، تختلف في الحقيقة عمّا يذكره أصحاب علم الهيئة (أي علماء الفلك)، وإن كان ما قالوه يعطيه الدليل العقلي، ولكن يؤكِّد ابن العربي أنَّ العلم الكشفي يعطي غير ذلك.[9] وبالتالي فإنَّ النظريّات الفلكيّة والفيزيائية السائدة كنموذج الانفجار العظيم والنظرية النسبية وميكانيك الكم، قد لا تكون صحيحة على الإطلاق، في رأي علماء التصوُّف، رغم أنّها يمكن أن تكون حلاًّ منطقياً للملاحظات والتجارب والقياسات التي يقوم بها العلماء.
وفي ذلك يقول ابن العربي شعراً في الديوان الكبير:
|
هذا الوجودُ الذي بالعُرْف نعرفه |
|
ليس الوجودُ الذي بالكشفِ نعلمُه |
ولكنَّ هذا الكلام مهما يكن غريباً يذكّرنا بنموذج أرسطو/بتولومي الذي يعدّ الأرض مركز العالَم وكيف أنّ هذا النموذج الخاطئ بقي قروناً عديدةً مقبولاً بين العلماء والفلاسفة لأنّه قدّم حلاًّ رياضياً صحيحاً يصف الحركة الرجعيّة لبعض الكواكب، ولكنّ هذا الحلّ الرياضي الصحيح لم يكن يوافق الواقع، مما خدع العلماء لفترة طويلة من الزّمن وأدّى بهم لقبوله وعدم التفكير في البدائل حتى أتى كوبرنيكوس وقال إنّ الشمس هي مركز العالَم.
فليس كل حلّ رياضيّ صحيح يصف الواقع بالفعل، وإذا كان نموذج الجوهر الفرد يخدع البصر ويجعلنا نرى الصور المتكرّرة كأنّها أجسامٌ تتحرّك مثلما يحدث على شاشة التلفزيون فكيف يمكن أن نثق بالحلول الرياضيّة ونركن إليها دون مناقشة البدائل المحتملة مهما تكن بعيدة.
[1] الفتوحات المكية: ج1ص153س33.
[2] الفتوحات المكية: ج1ص307س12، ج3ص7س21. وانظر أيضاً في كتاب "ما لا يُعوّل عليه" من ضمن مجموعة رسائل ابن العربي (دار صادر): الرسالة رقم 16، ص2؛ حيث يقول إنّ الكشف الصوري دائماً يكون صحيحا لكنّ الخطأ قد يقع في تأويل المُكاشف مما أريدت له تلك الصورة التي ظهر له فيها هذا العلم على زعمه.
[3] الفتوحات المكية: ج2ص677س1.
[4] الفتوحات المكيّة: ج1ص288س27.
[5] الفتوحات المكية: ج1ص154س22.
[6] الفتوحات المكية: ج3ص275.
[7] الفتوحات المكية: ج2ص208س27.
[8] الفتوحات المكية: ج1ص39س7.
[9] الفتوحات المكية: ج2ص670س7.

Solving the Arr...
Solving the Maj...
Selected Favori...
Published Books...
Arabic Articles...
Curriculum Vita...
Welcome to my W...
